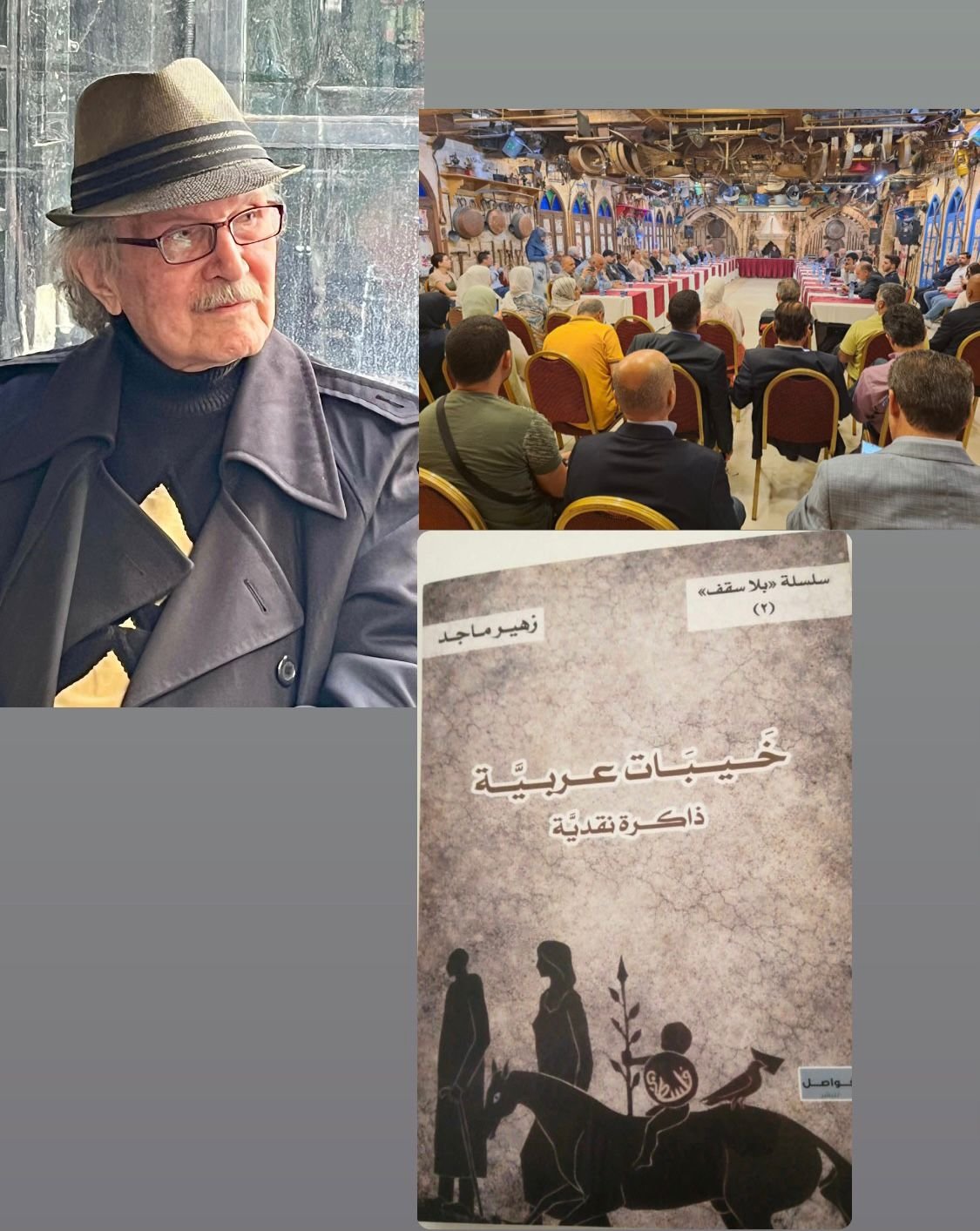فلسفة الزمن عند هايدغر وابن خلدون: مقاربة في الوعي التاريخي بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي
بقلم: آية علي الزين
الملخّص
تُعَدّ مسألة الزمن من القضايا المحورية في الفلسفة والفكر الاجتماعي، إذ ارتبطت دومًا بفهم الإنسان لذاته ولموقعه في العالم. يقدّم مارتن هايدغر في كتابه “الوجود والزمان” رؤية فلسفية تجعل الزمن شرطًا أساسيًا لفهم الكينونة الإنسانية، بينما يطرح ابن خلدون في “المقدّمة” تصوّرًا دوريًا للتاريخ يقوم على قوانين العمران البشري وتعاقب الدول. تهدف هذه الورقة إلى مقاربة فلسفة الزمن عند كلّ من هايدغر وابن خلدون، عبر إبراز نقاط الالتقاء والاختلاف بين منظور أنطولوجي غربي ومنظور اجتماعي–تاريخي عربي إسلامي، وصولًا إلى قراءة نقدية تُظهر كيف يمكن لثنائية “الزمن/التاريخ” أن تُغني الفكر المعاصر.
المقدمة
منذ أن بدأ الإنسان في طرح الأسئلة الكبرى حول الوجود والمعنى، كان الزمن حاضرًا بوصفه سؤالًا لا ينفك يثير الحيرة. فالزمن ليس مجرد إطار خارجي للأحداث، بل هو جوهر في تشكيل الوعي الفردي والجماعي. في الفلسفة الغربية الحديثة، مثّل هايدغر أحد أبرز من أعادوا التفكير بالزمن، معتبرًا أنّ فهم الكينونة لا ينفصل عن تجربة الإنسان الزمنية. أما في التراث العربي الإسلامي، فقد شكّل ابن خلدون علامة فارقة حين قدّم نظريته في العمران البشري، حيث الزمن يأخذ شكل دورة تاريخية تُعيد إنتاج ذاتها وفق قوانين اجتماعية.
تتساءل هذه الورقة: كيف يفهم هايدغر الزمن باعتباره شرطًا لفهم الوجود، وكيف ينظر ابن خلدون إلى الزمن باعتباره دورة اجتماعية–تاريخية؟ وما الذي يكشفه هذا التباين عن اختلاف الرؤى بين الفكر الغربي والشرقي؟
أولًا: الزمن عند هايدغر – شرط الكينونة والوجود الأصيل
ينطلق هايدغر من نقد الفلسفة الميتافيزيقية التي اختزلت الزمن في لحظات متعاقبة (ماضٍ – حاضر – مستقبل). في كتابه “الوجود والزمان” (1927)، يربط هايدغر بين الكينونة الإنسانية (الدازاين) والزمن، معتبرًا أنّ الإنسان لا يمكن أن يُفهَم إلا من خلال انفتاحه على الزمن.
- الماضي عند هايدغر ليس مجرد ما انقضى، بل هو “المرجعية” التي تنبني عليها هويّة الإنسان.
- الحاضر ليس لحظة جامدة، بل هو مجال الانخراط في العالم وممارسة الفعل.
- المستقبل هو الإمكانية، أي انفتاح الكائن على ما يمكن أن يكون.
هكذا يصبح الزمن عند هايدغر بنية وجودية تحدّد معنى “الأصالة”؛ فالإنسان الأصيل هو من يعترف بفنائيته (الموت) ويحوّل هذا الاعتراف إلى دافع للعيش بمعنى.
ثانيًا: الزمن عند ابن خلدون – الدورة التاريخية والعمران البشري
على الضفة الأخرى، يقدّم ابن خلدون (1332–1406) في “المقدّمة” منظورًا تاريخيًا–اجتماعيًا للزمن. فالزمن عنده ليس مجرد تعاقب كرونولوجي، بل هو حركة العمران: نشوء الدول، صعودها، ازدهارها، ثم تراجعها وانهيارها.
- المرحلة الأولى (النشوء): تبدأ الدولة بقوة العصبية والاندفاع.
- المرحلة الثانية (الازدهار): تبلغ الدولة أوجها بفضل التنظيم والاستقرار.
- المرحلة الثالثة (الانحدار): تسود الترف والفساد، ما يؤدي إلى الضعف والسقوط.
إنها دورة أشبه بقانون طبيعي يعيد إنتاج نفسه. الزمن هنا ليس خطًّا مستقيمًا بل حلقة متكررة، تعكس وعي ابن خلدون بحدود القوة البشرية وبحتمية التحوّل التاريخي.
ثالثًا: مقارنة بين الرؤيتين
- البعد الفلسفي/الأنطولوجي: هايدغر يجعل الزمن أساسًا لفهم الوجود الفردي، بينما ابن خلدون يجعله إطارًا لفهم العمران الجماعي.
- الخط المستقيم والدائرة: الزمن عند هايدغر منفتح على المستقبل (خطّ ممتد)، أما عند ابن خلدون فهو دورة تتكرّر.
- الموت مقابل السقوط: هايدغر يربط الزمن بوعي الإنسان بفنائيته الفردية، بينما يربطه ابن خلدون بفناء الدول والحضارات.
- التأثيرات الثقافية: هايدغر ابن الحداثة الأوروبية، حيث سؤال الفرد في مواجهة العدم، في حين أنّ ابن خلدون ابن الحضارة الإسلامية، حيث سؤال المجتمع والدولة في مواجهة التحوّل.
رابعًا: نحو قراءة نقدية معاصرة
تكشف المقارنة عن بعدين متكاملين:
- الزمن كشرط وجودي: يساعدنا على إدراك أصالتنا الفردية ومعنى حياتنا (هايدغر).
- الزمن كقانون اجتماعي: يمكّننا من فهم مسارات الحضارات وسنن التاريخ (ابن خلدون).
في عالمنا اليوم، حيث الفرد يعيش قلق الموت واللاجدوى، والمجتمعات تواجه دورات من الانهيار والنهضة، يمكن أن يشكّل الجمع بين الرؤيتين أفقًا غنيًا لفهم أعمق للزمن: ليس خطًّا مطلقًا ولا دائرة مغلقة، بل مسار حلزوني يجمع بين التجربة الفردية والدورة التاريخية.
الخاتمة
تُبرز فلسفة الزمن عند هايدغر وابن خلدون اختلافًا جذريًا في زاوية النظر: الأول ينطلق من سؤال الكينونة الفردية، والثاني من سؤال العمران الجماعي. ومع ذلك، فإن الجمع بين المنظورين يكشف أن الزمن ليس حقيقة واحدة، بل هو شبكة متعددة الأبعاد: أنطولوجية، اجتماعية، تاريخية. إنّ التفكير في الزمن بهذه الصيغة التكاملية يفتح أمام الباحث المعاصر إمكانيات جديدة لفهم علاقة الإنسان بالتاريخ، ويعيد صياغة النقاش الفلسفي حول المصير الفردي والجماعي على حد سواء.
مراجع مقترحة (للاستزادة)
- مارتن هايدغر، الوجود والزمان، ترجمة: فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد المتحدة.
- ابن خلدون، المقدمة.
- عبد الرحمن بدوي، الزمان الوجودي عند هايدغر.
- طه عبد الرحمن، روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية.
- محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي.